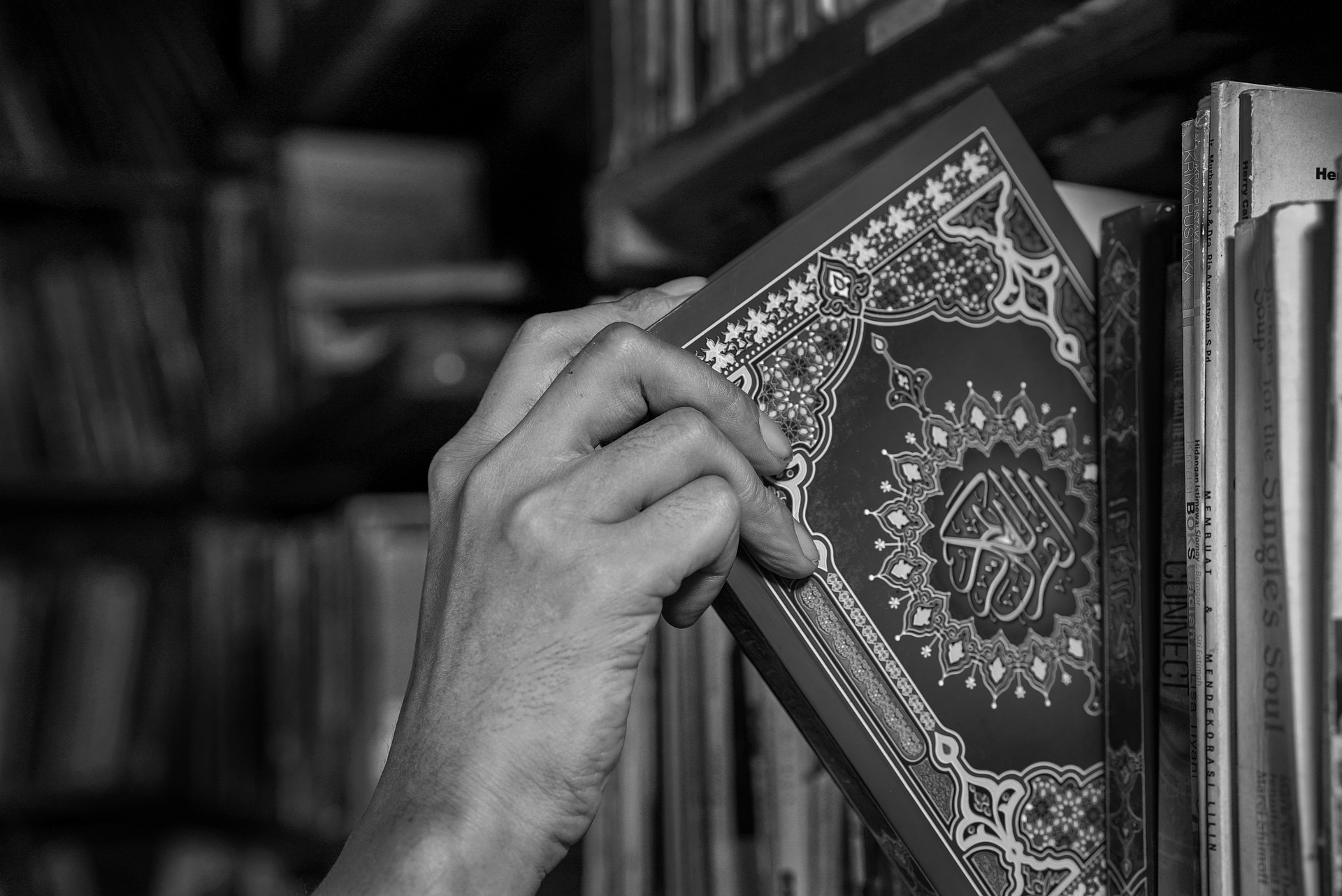دورة تكوينية لفائدة المحفظين
تحفيظ القرآن الكريم: الدور الحضاري والخصوصية المغربية
رفقة السيد الرئيس- رياح- الكتامي- البرينصي
بمقر المجلس- الخميس 25- 7- 2024
تحفيظ القرآن الكريم وتشكيل الشخصية المسلمة
تقديم:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله،
ممتن جدا للسيد الرئيس أن أتاح لي الفرصة للقاء بكم في هذا اليوم الأغر، الذي نتدارس فيه كتاب الله بيننا، فنرجو الله سبحانه أن تحفَّنا الملائكةُ فيه، وتغشانا الرحمة، ويذكرنا الله في من عنده.
أيها الأحبة الأكارم، نريد أن نتقدم بين أيديكم الكريمة بكلمة نبيِّن فيها أدوارَ تحفيظ القرآن الكريم في بناء شخصياتنا، وآثارَه في تحقيق الامتدادات المستقبلية لتأثيراته على غيرنا. وليكن ما نريده متمثلا في الآتي:
أولا- بالقرآن الكريم يُعرف الله تعالى:
إن مَن يطوف بجنبات سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو إلى الله في يوم من الأيام إلا بالقرآن الكريم؛ «إذ لا يُعرف الله إلا بمعرفة القرآن»[1]. فبه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوتَه، وبه تَستمر بحول الله تعالى. ولقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «أولُ من قدِم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: مصعبُ بنُ عمير، وابنُ أم مكتوم، فجعلا يقرئاننا القرآن»[2].
والقرآنُ الكريم، بعد هذا، يشتَمل على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فمِن الأسماء الرحمن والرحيم والحي والقيوم والغفور والكريم والجواد والخالق والرزاق، ومن الصفات القدرة، والحياة، والسمع، والبصر… إلخ. وهي جميعها تدعو المؤمن إلى التدبر فيها، وإيلائها ما تستحق من الغوص في معانيها، فبها يعرِّفنا القرآنُ الكريم ربَّنا سبحانه، وبها يدلُّنا على الطريق الذي إذا تمسكنا به استطعنا أن نرى ربنا سبحانه من خلال أسمائه وصفاته.
وقد يرى بعض الناس أن من أسماء الله الحسنى ما يشترك فيها مع خلقه، مثل: الرحيم، والكريم، والجواد… فذلك لا ينقص من حق الله شيئا، وإنما هو داخل في ما عبَّر عنه أبو تمام بقوله:
لا تُنكرُوا ضربي له مَنْ دونه **** مثلاً شرودًا في النَّدى والبَاس
فاللهُ قد ضَربَ الأقلَّ لنوره**** مثلاً مـن المِشكـاة والنبرَاس
والقرآن الكريم، حقيقةً، حين يمثل قاعدةَ التعريف بالله وأصلَه الأصيل، فإنه يمثل قاعدة الدعوة إلى الله تعالى. وما الدعوةُ إلى الله سبحانه سوى «تعريفٍ بالله»[3].
ثانيا- القرآن الكريم يدعو الشخصية إلى إعمال العقل/ التدبر:
يعيش كثير من الناس هَمَلا، فلا ينتبهون إلى ما يدور من حولهم، ولا يلتفتون إلى آيات الله المبثوثة في الكون، كما قال الله تعالى: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105)﴾ (يوسف: 105)، ولكن القرآن الكريم يَبنِي شخصياتِنا بدعوَتنا إلى إعمال العقل والتدبُّر في الآيات، وإلى الوقوف على المعاني والدلالات، حتى نختلف عن غيرنا ممن لا يلتزمون هذا المهيَع، ولا يسلكون هذه السبيل، فيقول ربُّنا سبحانه في غير ما آية: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)﴾ (النساء: 82)، ويقول جل جلاله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204)﴾ (الأعراف: 204)، ويقول عز وجل: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (9)﴾ (الإسراء: 9)، ويقول سبحانه: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17)﴾ (القمر: 17).
فقارئُ القرآن الكريم وحافظُه ومحفِّظُه حينما يَفقَهون حقيقةَ تدبرِ القرآن الكريم وإعمَالِ العقل في تلقِّيه، ويدركون أنهم مدعوُّون إلى ذلك في كل صغيرة وكبيرة، فإنهم يعلمون حينها حقيقةَ القرآن الكريم نفسِه، فهو لم يأت إلا رحمة وسعادة وعفوا وعافية للعالمين، قال سبحانه: ﴿طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (2) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (3)﴾ (طه: 1- 3)، فيزيدُهم إقبالا عليه وارتباطا به؛ إذ إن الشقاءَ الحقيقي هو ما يُعانِيه غيرُهم ممن إذا ذُكر الله وحدَه اشمأزَّت قلوبُهم، وإذا تُليَت عليهم آياتُه ما زادتهم إلا نفورا.
فاستجابتهم لدعوة القرآن الكريم إلى التدبُّر تدفعُهم إلى أن يُولُوا الآيات والعبارات والكلمات ما تستحق من معنى، وما تشتَمل عليه من دلالة، فيُبصرُون الحقائق، فيَنهَلون مما نهلَ منه سابقُوهُم بتدبُّرهم للقرآن الكريم، كما قال الأستاذ فريد الأنصاري- يرحمه الله تعالى- «نعم! لقد قادني التدبر للقرآن العظيم إلى أن أكتشف أن النظر لا يُغني عن الإبصار!»[4]، فيشمِّرون عن سواعد الجد من أجل العمل به حتى تصير أخلاقُهم قرآنا يمشي على الأرض، ولا يكون هدفُهم من حفظ القرآن جمعَه دون تنزيله وتطبيقه في واقع الناس، كما أشار القرطبي إلى ذلك، في الجامع لأحكام القرآن، بقوله: «وَإِنَّ الْغُلَامَ فِي دَهْرِنَا هَذَا يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيَّ فَيَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ لَا يُسْقِطُ مِنْهُ حَرْفًا، فَمَا أَحْسَبُ الْقُرْآنَ إِلَّا عَارِيَةً فِي أَيْدِينَا»[1]. إذ إن حفظ القرآن ما هو إلا وسيلة لتنزيله على الواقع وتطبيقه في الحياة.
ثالثا- القرآن الكريم يوجه الشخصيةَ نحو الاستقلالية:
لقد كان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تابعين لغيرهم من الفرس والروم، وكانوا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما بَعثَ الله نبيَه صلى الله عليه وسلم انقلبوا انقلابا كليا؛ فقد كانوا أذلة فصاروا أعزة، وكانوا فقراء فصاروا أغنياء، وكانوا جهالا فصاروا أساتذة العالم. ولقد كان دور القرآن الكريم في صناعة استقلاليتهم دورا بارزا؛ حيث علَّمهم أن الإنسان مستقل عن غيره في حسابه وثوابه وعقابه، ودفعهم إلى الاعتقاد المحض في أن النافع والضار هو الله تعالى.
ولطالما كانت توجيهات القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم قاصدة هذا الهدف، فنبَّهه بقول الله تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ (النساء: 84). ولكي لا يفهم بأن الأمر مقصور على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خاطب به المؤمنين، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (المائدة: 105).
ومن حفظ القرآن الكريم، يكون قد حاز النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه، فمنبع الاستقلالية بين يديه، والإقبال وعدم الإدبار مهماز يحثه كلما قصد إليه الارتخاء من إحدى جهاته الأربع.
رابعا: تحفيظ القرآن الكريم يعلمنا التزام التدرج في الحياة:
من السنن التي نتعلَّمها ونُعلِّمها حين تحفيظ كتاب الله تعالى سنَّةُ التدرج التي يكون لها، إذا تدبرناها جيدا، أثرٌ بالغ في الحياة. فلا شيء يتحقق دفعةً واحدة، ولا شيءَ يظهر على صورته الكاملة الناضجة ضربةَ لاَزب، ولكن خطوةً خطوة، حتى يبدوَ الصغير كبيرا، والضعيفُ قويا، والفسِيلةُ شجرةً باسقة مستويةً على سوقها، ذاتَ أغصان ممتدة في السماء، وظلال وارفة منبسطة على الأرض.
ولذلك، فإن الفقيه لما يتحمَّل المشقة في كل يوم ليقدِّم للطالب قسطا قليلا من القرآن، فإنه يعلم أن السَّيرَ على هذا المنوال دائما سيُوصل الطالبَ إلى حفظ كتاب الله في السنوات القليلة القريبة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ عز وجل أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ»[5].
ولقد ظهر ذلك بوضوح في طلب كتاب الله تعالى وحفظه من لدن كثير من الصحابة، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَعَلَّمَ عُمَرُ الْبَقَرَةَ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمَّا خَتَمَهَا نَحَرَ جَزُورًا»[6].
فإذا كان التزام التدرج في طلب كلام الله الذي بُني عليه الدين، فإن المسلمين لم يتوقف التزامُهم به عند حدوده- وهي أجلُّ وأعظم- فمدَّدوه، وعمَّموه، ليشمل حياتهم كلَّها، مستجيبين في ذلك كله لطبيعة النواميس والقوانين التي خلق الله سبحانه الخلق عليها.
خامسا- كتاب الله تعالى يوجه نحو جعل الأقوال من الأعمال:
كتاب الله تعالى كتابٌ عملي؛ ألفاظُه عملية، وتراكيبُه عملية، ودلالاتُه عملية، ومعانيه عملية، فما جاء الدين، كما يشير فريد الأنصاري، إلا «ليكون حركة إنسانية في الزمان والمكان، لا نصوصاً تُتلى فقط، ولا قصصاً تحكى فحسب، وإنما الأمانة التي حملها الإنسان عَمَلٌ: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون﴾ (التوبة: 105)»[7].
لقد رُوي عن معاذ بن جبل أنه قال: «اعْلَمُوا مَا شِئْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا، فَلَنْ يَأْجُرَكُمُ بعلمه حتى تعملوا»[8]؛ ذلك لأنه روي في أدبيات المسلمين ألا قول إلا ما تحته عمل، بل إنه لا يقبل أن تُبنى العلاقات الدموية إلا على العمل، وليس على القربى والأعراق، كما في دعاء نوح عليه السلام وهو يتوسل إلى الله تعالى بأن يفعل بابنه خيرا، فقال: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ (هود: 45- 46).
فلنُقبل- نحن أهلَ القرآن الكريم- على الاشتغال به، وبما حام حوله، وأن نجتنب الجدل الفارغ الذي لا يأتي بخير، فمن الحِكَم المأثورة، أنه إذا أراد الله بقوم سوءاً سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل!
سادسا- حفظ كتاب الله يضمن التفوق وتحقيق التميز:
إذا تدبرنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للفتن التي تتهدد الناس جميعا، وسؤالَ علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن المخرج منها، فإننا نجده لم يُشر عليه بأكثر من القرآن الكريم، فقال: «كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ حَدِيثُ مَا قَبْلَكُمْ، وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ، وَفَصْلُ مَا بَيْنَكُمْ، وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، هُوَ حَبَلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ»[9]، إذا تدبرناه، فإننا نجده يدل على المحجة البيضاء التي لن يضل سالكها أبدا، ولن يهتدي من حاد عنها أبدا.
فإذا كتبت الهداية للمسلم، فإنه يكون أحسن الناس، وأطيب الناس، وأعلى الناس درجة، فيكون التفوقُ الحقيقي حليفَه، ويكون التميز عن غيره ميزته الأساس التي لا ميزةَ أجلُّ بعدها، كما كان شأنُ جحافل المسلمين في القديم.
عَنْ عامر بن واثلة؛ أن نافعَ بنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ. وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ. فَقَالَ:
– مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟
– فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى،
– قَالَ: وَمَنْ ابْنُ أَبْزَى؟
– قَالَ: مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا،
– قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟
– قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ.
– قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ “إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكتاب أقواما ويضع به آخرين»[10].
سابعا- واجبنا من أجل الاستمرار/ السقي والتجذير:
أستعير هاتين العبارتين من الأستاذ فريد الأنصاري- يرحمه الله تعالى- حيث يعني بالسقي المروحي القرآني الجلسات التي تكون بين المحفظ وتلامذته؛ حيث يتلقون على يديه، إلى جانب كتاب الله تعالى، الأخلاقَ الإسلامية، والرؤيةَ الشرعية السليمة الواضحة، ويضعهم على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد ضرب لتوضيح هذا المصطلح المرحلة الأرقمية، والمرحلة المنبرية من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
ولنا أن نتساءل عن الكيفية التي انتشر بها الإسلام، وعمَّ بها الأرضَ كلَّها، فهل مرحلة السقي المروحي القرآني هي التي فعَلت فعلَها. وهنا يورد الأستاذ الأنصاري مصطلحه الثاني: التجذير، فيقول: «وأما التجذير فهو غرس جذور المقبلين على الخطاب القرآني وبصائره، المستزيدين من حقائقه. وإنما التجذير المفيد هاهنا هو (التجذير المتعدد الإنبات)، ذلك أن جذور النبات والشجر على نوعَين: نوعٍ مقتصرٍ في وظيفته على نبتة واحدة، أو شجرة واحدة؛ إمداداً عموديّاً بالماء والغذاء، ونوعٍ ثان له طبيعة متكاثرةٌ متناسِلة، بحيث تتعدَّى وظيفتُه إمدادَ شجرته أو نبتته؛ إلى إنبات شجرة أخرى جديدة، أو إخراج نبتة أخرى جديدة، بصورة أفقية، تتكاثر شجراً، أو نباتاً متناثراً هنا وهناك، فمثال ذلك في الشجر: القصبُ والصفصافُ ونحوُهما، ومثالُه في النبات: النجمُ البَري، وكذلك النجمُ الرومي الذي تزيَّن به اليوم الحدائقُ العامة»[11]. ومن خلال ذلك، فإن المطلوب أن يَحرص محفُظ القرآن الكريم على أن تكون ثمراتُه في التحفيظ على هذا المنوَال، فيكون منها شيخٌ هنا، وشيخٌ هناك، حتى تعمَّ الأرضَ خيراتُ القرآن وفضائلُه. «فبهم يسقي الله الغيث، وينفي العدو، ويدفع البلاء، فوالله لهذا الضرب من حملة القرآن أقلُّ في الناس من الكبريت الأحمر»[12].
فإذا تحقق هذا الفضل فإنه يكون فضلا عميما، وأمرا عظيما، ولكن الأجدى منه- كما يشير عبد الله دراز في مقدمته للظاهرة القرآنية لمالك بن نبي- أن يُشمِّر كلُّ حافظ أو محفِّظ تيسَّرت له موهبةُ الكتابة، بعد توفر الإيمان والعلم، أن يعلَم أن «واجباً آخر يقع على عاتقه: إنه إخراج ثمار علمه بلغة عصره، كما يفعل نبي يخاطب قومه بلغتهم»[13]، عسى أن يشملنا القول النبوي الصحيح: «إن لله تعالى أهلين من الناس: أهلُ القرآن هم أهلُ الله وخاصتُه»[14].
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين أجمعين.
[1] – بلاغ الرسالة القرآنية؛ من أجل إبصار لآيات الطريق، فريد الأنصاري، دار السلام، القاهرة، ط1، 1430هـ -2009م، 55.
[2] – رواه البخاري.
[3] – بلاغ الرسالة القرآنية، فريد الأنصاري، 90.
[4] – المرجع نفسه، 18.
[5] – رواه أحمد، 42/ 194
[6] – الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 1/ 40.
[7] – بلاغ الرسالة القرآنية، فريد الأنصاري، 153.
[8] – تفسير القرطبي، 1/ 40
[9] – رواه الطبراني في مسند الشاميين.
[10] – رواه مسلم.
[11] – بلاغ الرسالة القرآنية، 174.
[12] -الحوادث والبدع، أبو بكر الطرطوشى، 99.
[13] – الظاهرة القرآنية، مالك بن نبي، 11, (مقدمة عبد الله دراز).
[14] – رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم.